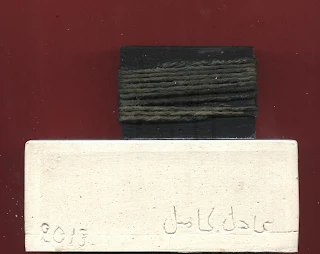7 قصص
قصيرة
عادل كامل
[1] أحلام ميت
عندما لم يعد لدي ّ، في الواقع،
عندما لم اعد احتمل حياتي، قررت ان أؤدي الدور الذي يقوم به الميت. فها أنا، لا
اعرف ان كان الوقت نهارا ً قد اندمج في الظلمات، أم ان الليل تخفى عبر إشعاعات
الشمس، ولا أريد ان أدرك ما إذا كانت لي جاذبية، وزمن مرتد، أو سالب، أو أنني أعيش
ما بعد الزمن، أو من غير زمن تماما ً. في الواقع لا أريد ان اعرف أنني اعرف هذا
الانعتاق من المعرفة، فانا لست كائنا ً كي يكون لي امتداد الكائنات، حتى لو كنت
عدما ً. فانا لست بحاجة لقراءة ما إذا كنت ذهبت من الموت إلى مكان ما، أو أنني
استيقظت، كي أكون مقيدا ً بالمعادلة ذاتها التي تحتم على البذرة ان تدفن كي تورق،
فهل حقا ً خطرت ببالي هذه الأطياف الشاردة عندما سمعت رنين الهاتف، وعندما رأيت
أصابعي تمتد وترفع السماعة كي أصغي:
ـ هل أنت السيد عادل كامل..؟
ـ بالتأكيد لا امتلك إجابة واضحة
على مثل هذا السؤال.
ـ ماذا تقول...؟
ـ أنا أتكلم بشفافية، فانا، قبل ...، كنت قررت الانتقال إلى المكان الذي لا
عودة منه.
ـ وهل ذهبت..؟
ـ يبدو ان بعض خلايا دماغي لم تتوقف عن العمل بعد، وفي اعتقادي إنها لن
تتوقف مادامت خلايا الكون كلها تعمل على النحو الذي يتجاوز إدراكي هذا في ...
ـ أصغ إلي ّ.
ـ وكيف اعرف أنني امتلك قدرة الإصغاء..؟
ـ انك ارتكبت إثما ً كبيرا ً..
ـ هذا يعني إنني لم ارتكب الإثم، حتى الآن!
ـ حتى لو لم ترتكبه، فأنت شرعت بارتكابه..
ـ لا إجابة واضحة لدي ّ..
ـ بل لمجرد انك كنت فكرت فيه، أو نويت...
ـ لكنني لا استطيع ان أتراجع.
ـ اسمع، هل تدرك ما يترتب عليك من عقوبات...؟
ـ بالضبط، لم يعد الآمر يعنيني. فأنا كنت مت يا سيدي.
ـ انك ارتكبت الإثم الأعظم، ومازلت لا تطلب الغفران!
ـ أنا، عندما كنت حيا ً، لم افعل ذلك، فهل استطيع ان افعل ذلك، وأنا بين
يديك، جثة صغيرة في طريقها إلى الزوال. فأنت تعرف أنني لم اخبر أحدا ً بالمكان
الذي أنا فيه.
ـ كأنك ولدت كي ترتكب ما لم يرتكبه إنسان.
ـ بل ولم يرتكبه حتى النبات، أو الحيوان!
ـ وها أنت تصر، بعناد، كما في حياتك، ولا تطلب الرحمة.
ـ يا سيدي، أنا قلت، قبل نصف قرن، ان ما هو أقسى من الموت، هو الرحمة!
ـ ولا تطلبها..؟
ـ أنا اطلب ان أموت، ان أموت فقط، وان تخلصوني مني، يا سيدي، تاركا ً
الرحمة لكم جميعا ً. لأنها وحدها طالما كانت أكثر قسوة من انتظار الموت، ومن الموت
الذي يبدو انه غدا يمسك بباب الرحمة، ومفاتيحها.
[2] كلمات
وتابع المحاضر:
ـ "إنها تعيد هدم كل ما أصبح عتيقا ً، وإعادة صياغته من جديد. فهي
تدفع بالبحث إلى الجذور، محفزة الطاقات الكامنة، واللا مرئية، للاختراع،
والاكتشاف، على صعيد العلوم كلها؛ من الطب إلى الفيزياء، ومن العلوم الخالصة إلى
الجماليات، فهي تضع حدا ً للرتابة، والملل، واللامبالاة، ولا تسمح للحياة ان تمضي
من غير استنفار الطاقات النائية، والبحث عن مناطق لم يصلها الوعي من قبل. فهي
تستحدث، اجل، عظمة النشوة، وذروتها، وتفتتح مجالات نادرة للهيمنة، والسيطرة،
والظفر العظيم.."
لم ينهض ويغادر قاعة المحضرات،
مكتفيا ً ـ مع نفسه ـ بتأنيب الضمير، إنما، وهو يخفي ابتسامة كادت تفضحه، شعر انها
محض محاضرة غامضة، ومغرضة، ومضيعة للوقت، في نهاية المطاف. لكنه تابع الإصغاء:
ـ " ولو أعدنا تفكيك تاريخ الحقب، وما أنتجته، لكانت هناك أدوات،
ومخترعات، وفتوحات ما كانت ستحدث أبدا ً لولا هذا الانشغال بالعبور من عصور
الظلمات إلى عصور التنوير، والرفاهية...؛ أدوات، واكتشافات، وتطبيقات، بل ومعجزات
...."
إلا ان جسده لم يسعفه، عندما
حاول النهوض، فتخلى عنه، بينما كان المحاضر يواصل خطابه:
ـ " فهذا القانون الراسخ، القديم قدم رغباتنا بمقاومة الهزيمة،
والخمول، والغياب، عمل على إعادة قراءة كل تاريخنا المدفون، ونبشه، من اجل تعزيز
آليات التقدم، وعدم النظر بعيون عمياء، بل سبر المسافات التي مازالت كلما اقتربنا
منها تزداد بعدا ً، وغورا ً في المجهول...."
لا يعرف هل تحول إلى طيف، أو تخلى
عن جسده، أو تحول إلى أثير، كي يجد انه أمام النهر. كم ود لو حدث الطوفان، إنما،
لأنه لم يعد يمتلك لا رغبة ولا نية ولا قدرة على المقاومة، ود لو غادر مسيرة حياة
طالما رآها تتكوم في ماضيها. آنذاك ترك التصوّرات التي تكدست عبر عقود من التراكم،
تنحدر، نحو الماء، كعقاب، هو وحده، دار بخلده، جعله ألا يتذكر، انه، في ذات يوم،
شارك في: الحرب.
[3] الحكيم والعذراء
" كثير من التحولات لا
تحدث إلا متزامنة، كانتصاب القامة لدى الإنسان استعدادا ً للمشي، وانتقال عمل
الحواس من العشوائية إلى التخصص، ودور اليد في الذهاب ابعد من عمل الأرض، بصياغة
مفاهيم مستحدثة، كان للفكر ـ بعد الرحم ـ دور المنتج، ومن ثم، الوعي بالسببية،
والعبور من الأسطورة ـ حتى بدحضها أو تفكيكها ـ نحو المجال العملي، بما يمتلك من إجابات
قائمة على التجربة، وإدراك ان التحول من المصادفة إلى القصد، شبيه بما تؤدي إليه
تحولات الكم إلى نوع له موقعه في التقدم. فالتزامن ما هو إلا ترابط المحركات ـ
ومنها المخفية واللا مرئية ـ بالمستحدث، والمبتكر، الذي يتلاءم مع الوقائع
الجديدة..."
بعد ان أصغت إليه، شرد ذهن
الطالبة، التي طلبت من أستاذها العجوز، ألا يذهب بعيدا ً، فلا احد تعنيه ما تخفيه الأسباب،
كي تنتج لا أسبابها، فهي تود لو لخص لها
ليس علامات التحول، بل تحول العلامات.
فمد يده من غير إرادة، وامسك بأصابعها،
وراح يضغط عليها بشدة.
كادت تصرخ، ذاهلة، وهي تتحسس
نبضات قلبه كمسمار اخترق جسدها.
هو الآخر، شرد ذهنه، فقد كان يود
لو اخبرها، ان أصابعها لها لون الغيوم، وملمسها كبرعم يتفتح توا ً، وخصلات شعرها
كسرب طيور، وعطرها طالما سمح له ان يستدل على مكانها في العالم، فيما صوتها تدثرت
فيه أسرار بذور الخلق، ونظراتها أصبحت مثل شرارة حريق لا يأمل ان يدفن تحت رماده..!
ـ " كثير من التحولات لا تحدث إلا متزامنة..."
إنما كادت تبكي، وهي تصغي إلى
صوت كلماته تارة، والى كلماته من غير صوت، تارة أخرى، مختتما ً الدرس، بسؤال:
ـ " وهل قلت شيئا ً ملتبسا ً...؟"
ـ "أستاذ ..."
لأنها كانت حدست بماذا كان يحلم،
وليس بما كان يفكر، أو يرغب. كلا، صدمها، وهو يحدق في رأسها:
ـ " متى تم التحول...؛ من الأرض إلى الفكر، ومن الفكر إلى عالم راح
ينتج مصيره بعيدا ً عنا...؟"
مستدركا ً:
ـ " كنت أريد ان أقول ...، ما هذا الذي يذهب ابعد منا ...؟"
قالت:
ـ " تقصد ....، هذا الذي يتحدى نهايته..؟"
لم يجد ثمة علاقة ما بين فمه ـ
وهو يتمتم ـ وبين ما كان يدور داخل خلايا دماغه، قال، انه لم يعد يميز ما إذا كانت
الرحمة وحدها تمد بعمر الموت، أم ان الموت استبعد أو أقصى حضورها، إليه.... فهو ـ
دار بخاطره ـ لم يعد يرغب ان يفك لغز ما إذا كانت الظلمات وجدت مخبأها في الضوء، أم
ان النور راح يمنحها اتساعها، نحوه، وقد أصغى إلى أصوات نائية رآها تتناثر محفزة
لديه الاحتفاظ بفجوات ما بين حافات الحلم وحافات الاستيقاظ.
ـ " عدنا إلى الأرض، إلى آلهتنا الأولى، إلى الرحم!"
كان يود ان يخبرها انه طالما
استدل عليها بمحض استنشاق الهواء، أو مراقبة أطياف الشمس، أو سماع الأصوات، لكنه
أغلق فمه. فالإنسان، فكر مع نفسه، لا يمتلك إلا ان يتدرب على حمل ما لا تستطيع
الأرض حمله. فقالت فجأة:
ـ " أراك تفكر بهذا الذي لا يمكن الاستغناء عنه، لكن الذي يبقى أبدا ً
غائبا ً في هذا الحضور..؟"
لم يجد فمه كي تكون ثمة كلمات، وما ان وجد الكلمات حتى لم يجد فمه. كان
يراها ترفرف أمامه كحمامة لها مخالب نمر. ومضات تبث نداءات سمحت له ألا يجد في
العلقم إلا لغز الغواية، وفي الأخيرة مرارات ما بعد الارتواء من الأسرار.
بشرود أصغى إلى صوتها، غير مكترث ما اذا كان قادما ً من المجهول، أو متجها ً
إليه:
ـ " أستاذ ....، أنت معي، منذ ربع قرن، ولم تبح لي...، بهذا الذي كنت
أنا ـ تلميذتك ـ في ذات يوم، أود ان أراه وقد غدا لا ينتظر الشرح، أو حتى التأويل،
إنما، هذه هي الحكمة، إن حصلت عليها قبل الأوان، لا فائدة منها، وإن جاءت متأخرة،
فلا آسف عليها...؟!
25/6/2013
[4] سعادة
تلصص من خلف النافذة: لا أصوات،
بعد ان لم ير أي اثر للضوء في البيت، ولا في غرفتها التي طالما جلس فيها، معها،
وقضيا أزمنة مرحة. أتراها رحلت، من غير ان تخبره ...، مع انه، في آخر لقاء معها،
قبل أشهر، أخبرته بأنها وزعت ما تمتلكه، فلم يعد لديها، إلا سريرها، وخزانة
للملابس...، حتى المرآة لم تعد بحاجة إليها، ولا التلفاز ..
أتراها ـ سأل نفسه ـ برهنت ان
حياتها، لم تعد سوى ذكرى، إن لم تكن قد محت أي اثر دال عليها، بعد عقود كانت فيها
محط أنظار الجميع، وعلامة لمدينتها.
كان منزله يقع على بعد أمتار من
بيتها، وكلما مر، ورأى المصابيح أو سمع أصوات خطاها، أو أغنية ما كانت تتمتم
بكلماتها، لا ينشغل بأمرها، وكأنها، دار بخاطره، مثله، تعيش حياتها مثل شجرة في
غابة نائية.
إنما ـ خطرت بباله ـ حكاية ما قديمة لسيدة عجوز لم يبق لديها إلا
قفص الطائر الذي مات، فكان القفص هو عزاءها الأخير، في وحدتها، ولكن الذي لا تعرف
من حطمه وحوله إلى نفاية.
لم يخط خطوة واحدة، لا إلى
الخلف، ولا إلى الأمام، ولكنه لم يكن مستعدا ً لقرع الباب، أو سؤال الجيران عنها.
فقد شعر ان شيئا ً ما من الذعر يدّب فيه حتى جمّد عاطفته، ومنعه من الاختيار.
أتراها استغنت عن النور، بعد ان فقدت بصرها، وتخلت عن الغناء، بعد ان فقد قدرتها
على سماع الأصوات ...، بعد ان اقتربت حياتها من حافات النهاية..؟
إنما من يقرر ذلك ..؟ ها هو
يستعيد صخب الجلسات، وشغفها بسماع
الموسيقا، وقراءة الكتب، ومتابعة أخبار الفنون، والاكتشافات العلمية، وتلذذها
بحياة شفافة بعيدا عن العزلة، فقد كونت حياتها، مثلما تبني الطيور أعشاشها، في
أعالي الأشجار، ولكنها، لم يخطر ببالها، إنها ستتعلم كيف تبلغ درجة الاكتفاء
بذاتها، بعد ان تقدم العمر بها، وأصبحت تكرر إنها تعيش من غير رغبات، بل حتى من
غير أحلام. وأنا ـ سأل نفسه ـ ماذا كنت سأفعل من غير الكتب، ومن غير متابعة
مباريات الكرة، والعناية بنباتات الظل، بعد ان ذهب أفراد العائلة كل إلى سبيله...؟
إنها ـ إذا ً ـ ليست بحاجة
لتغني، أو لسماع الأصوات، وإنها ليست بحاجة إلى الضوء أيضا ً، فقد غدا بلا نفع،
وربما لم تعد بحاجة إلا للقليل من الماء، والقليل من الطعام، فعندما لا يعرف المرء
اهو الذي أصبح زائدا ً على الدنيا أم ان الحياة برمتها هي التي أصبحت فائضة، لا
يكترث كثيرا ً بالمسافة بينهما، ولا بمن يكون هو السبب، في اندماجهما، أو في
اتساعهما!
مضى، كما في كل مرة، إلى بيته،
بخطوات لا صدى لها، في ظلام الليل. وعندما وجد نفسه في صالة البيت، لم ير ....،
إلا الكرسي القديم بجوار طاولة الكتابة، التي طالما شاركته أداء العمل...، فيما تم
إخلاء البيت، تماما ً، وليس ثمة ما أهمل إلا صورا ً وإعلانات لم تنتزع من الجدران.
خلع ملابسه، وتمدد فوق السرير
القديم، تاركا ً الضوء، ومروحة يدوية تعمل، وكأنه، للمرة الأولى، كان يتمتع بلذّة
انه لم يعد يمتلك إلا قدرة استثنائية على استعادة حياة دمجت نهايتها بأطياف مرت من
غير أصداء، أو رفيف، أو أثر.
30/6/2013
[5] فجوات
مرة أخرى وجدت مصيري داخل
الجدران. فبعد ان أفقت، بدأت أدرك أنني تحولت إلى شكل لا حافات له، مثل مثلث فقد
زواياه تارة، ومثل مكعب وهمي لا نهايات له تارة أخرى، وكأنني أصبحت امتلك القدرة
ذاتها الأولى التي قادتني إلى هذا المصير: أنني لست أكثر من خلايا غاب مركزها. فقد
عدت متحررا ً من الصلابة، لكن المرونة، في الحالات كلها، سمحت لي بمراقبة ما كان
يحدث لي، بغياب الضوء، كي اكتشف ـ ومن غير دهشة ـ ان للظلمات أبعادا ً جذابة،
وكثافتها لا تقارن حتى بما يحدث في الأحلام. ها أنا طليق ...، من غير حركة، أو
مكان.
وها أنا، ببساطة، أقف أمام الإمبراطور.
وكم كنت أود ان اخبره، قبل ان يسألني، ان يرى الأشكال وقد غابت حدودها، وإنها
متوازنة مع فراغاتها، وان الأخيرة، هي الأخرى، لها شفافية فائقة السحر.
انتظرت. فلم يتكلم. انتظرت كي أجد
انني أصبحت داخل المكان الذي راح يمتد إلى ما لانهاية. ففي حضرته، فكرت مع نفسي،
يحدث هذا من غير حاجة للريبة، او الشك!
فقال لي:
ـ لم تصفق لي، ولم تهتف بحياتي، ولم تمجدني ...؟
فلم أفكر، لأنني قلت حالا ً:
ـ لو كنت فعلت ذلك، لكان عليك ان تعاقبني! فأنت، يا جلالة الإمبراطور، بما
تمتلك، خارج مدى المدائح، وضرورات الطاعة! فكل ثناء، أو تبجيل، أو حتى الامتنان،
لا يتناسب ومقامك الذي هو أعلى من ان يكون عاليا ً! فكيف تطلب مني ما هو خاص
بالمخلوقات الفانية..؟
عدت أرى الحدود: فأنا تحولت إلى
شكل تداخلت فيه النهايات، مندمجة، ومنفصلة، ومضطربة، حتى لم تعد لي حافات تحدد لي
كياني. وعندما سمعت من يطلب مني ان اهتف، واصفق، وامجد، وجدت فمي يتخلى عني،
وأصابعي تتراقص، وقلبي يغادرني، آنذاك كانت العاصفة قد بلغت ذروتها، لأنني لم اعد
أرى الظلمات كي يخطر ببالي ان القليل من الضوء، وحده كان يكفي لغيابي، وأن ما حدث
لم يكن سوى وهم ٍ جاورني قبل موتي، وسوى ومضات سكنت هذه الفجوات.
[6] ومضات
لم يرها منذ زمن بعيد، رآها
مصادفة في السوق، تتبضع، وكاد لا يعرفها حتى وهي تسد عليه الطريق، وتحدق في عينيه
الغائرتين، فمن تكون..؟ سأل نفسه، وتراجع خطوة إلى الخلف، كي يتابع تقدمه، لكنها
منعته، بحركة رآها غير عفوية...، فنظر إلى جسدها من الأسفل إلى الأعلى، ومن اليسار
إلى اليمين، ومن قمة رأسها إلى تراب
الأرض...، فتراجع خطوة، إلى الوراء، كي يراها بإمعان. إنها ليست هي...، وجال
بخاطره انه لم ير الفتاة التي كاد يقترن بها قبل أكثر من نصف قرن. فسمع صوتها
مميزا ً وجذبه بنبرته الناعمة، وقد تخللتها بحات، وتوقفات، ورنين خفيض، طالما جذبه
بما فيه من الغاز، ليونة غير قابلة للكسر، وصلابة لها طراوة نسيم الفجر، قبل ان
يجد انه توارى، هو، وقبل ان يراها توارت، هي، في ذات يوم مغبر، مضطرب، قبل عقود.
فسمع ما يشبه الصوت، أكان هو
صوتها، أم صوته، لا برهان أخير يثبت انه ـ أو أنها ـ فعل ذلك:
ـ انك كنت تبحث عن المصائر ...، والآن، أصبحت لا تجد حتى زاوية تحتمي بها!
إنما قال لها، أقال لها، أم قال
يخاطب نفسه:
ـ كل النهايات، في الأخير، لا تعزل عن مقدماتها..
وأضاف بصوت خفيض، أأضاف، لها، أم لم يفعل:
ـ وما يحدث، في هذه اللحظات، هو الآخر، يمتد...
عندما آفاق، لم يجد أحدا ً يمنعه
من التقدم، أو من التراجع، فتسمر برهة، وكأنه يحلق عاليا ً:
ـ هل تبحث عن احد، هل أضعت شيئا ً...؟
ـ لا ..لا ..
دار بخاطره انه كان لا يبحث عن
احد، متابعا ً، إنما هي التي همست: انك كنت تبحث عن المصائر كي تحتمي بك، لتمد لها
يد العون، والآن، والآن ليس حتى زاوية صغيرة تحتمي بها من هذا الغبار، حتى انك
أضعت مصيرك، أيها العجوز الظريف، وأنت أصبحت خارج مداك.
[7] الرحمة!
ـ الرحمة .. الرحمة.
ـ الرحمة أم الموت..؟
ذلك لأن الأخير، كان يحدق في
الفرن الحديدي، المسنن من الداخل، ببوابته الزجاجية الشفافة، وهو يستعيد الصوت
ذاته الذي طالما كان قد سمعه، لرئيسه، الذي صمم الفرن، كي يلقى خصومه مصائرهم فيه،
بعد ان يشعل النار، من الأسفل، مستمتعا ً بالمشهد، حتى يبلغ ذروته.
أما أنا، دار بخلده، فأريدكم ان
تتذكروا ما كان يحدث تماماً.
ـ الرحمة..
مصغيا ً للصوت يرتفع، بعد ان أشعل النار، من تحت، وتركها تسّخن الفرن، فكان
رئيسه، يستغيث تارة، ويصرخ تارة أخرى، وقد فقد صوابه.
كانت وسيلة تعذيب مبتكرة؛ غير تلك
التي كان يضع فيها الآخرين في القوارب، وقد ملأها بالزفت، ليشعل النار فيها كي
تلتهم النار أجسادهم، وتحولها إلى رماد، يذهب مع الماء، ماء دجلة.
ـ الرحمة...
فأجابه بصوت خفيض:
ـ الم تكن تستمع إلى استغاثتهم، وتضرعاتهم، وعياطهم، وعويلهم، وأنت توقد نارا
ً هادئة، لتسخين الفرن، تاركا ً درجة الحرارة ترتفع، حتى ترى كيف تخترق المسامير أجسادهم،
وهم يصطدمون بها، بحثا ً عن الخلاص، ينزفون، طالبين الرحمة! فكنت تقول لهم: الرحمة
أم الموت..؟
ورفع صوته:
ـ والآن ما الذي تطلبه، الموت أم الرحمة..؟ فانا طالما قلت لك، عندما عملت
معك مساعدا ً، ومثل ابن لك، لا ترحم أحدا ً بالرحمة! فكنت تقول لنا: الضوء القليل
وحده يكفي، مثل الرحمة، لسبر أغوار الجحيم.
لم يكف الآخر عن طلب النجدة،
فيما كانت درجة الحرارة ترتفع، قليلا ً قليلا ً، وجسده ينزف:
ـ هل أخبرك بالسر...؟
ابتعد مساعده عن الفرن قليلا ً
ليراه يتلوى. فقال رئيسه متابعا ً:
ـ لقد ارتويت من الرحمة التي لا تعرف أنها ...، لن تفنى! وهي أقسى من أي
موت!
فسأله:
ـ وماذا اكتشفت ...؟
ـ ستعرف ذلك بنفسك، عندما تكتشف ان الرحمة وحدها لا تحتمل!
فأجابه بلا مبالاة:
ـ ولكنني ارتويت حتى بلغت الرحمة ذروتها.
ـ لن ادعك تموت...!
وسحب النار، تاركا ً الفرن
يبرد، قليلا ً قليلا ً، كي يقرب النار منه بعد فترة، ولكن الآخر كان قد تكوم،
كصرة، بلا حركة.
قرب رأسه من الباب الزجاجي
الشفاف، وسأله:
ـ هل مت...؟!
لم يجب. نظراته كانت تقول:
ـ لو أطلقت سراحي، فستكون أنت، وأفراد أسرتك، وأبناء عمومتك، وعشيرتك،
الواحد بعد الآخر، من أضعهم في ..هذا ... الفرن. والآن، بعد ان أموت، ستبقى تبحث
عن مكان تلوذ به من الرحمة!
* من وحي
نشاطات بكر صوباشي، مدير شرطة بغداد، لعام 1620 للميلاد. والنهاية حقيقية، حيث
أسهم فيها، الابن، بتعذيبه، بقسوة، حتى نفق.